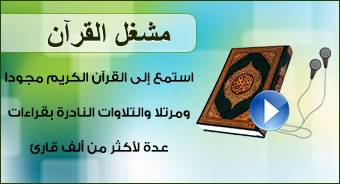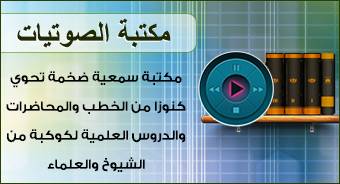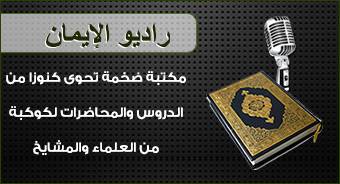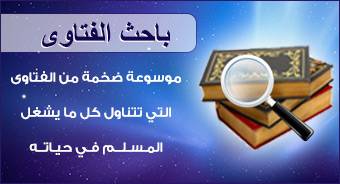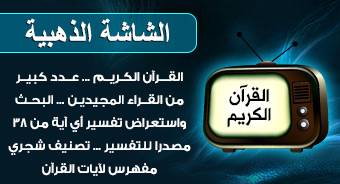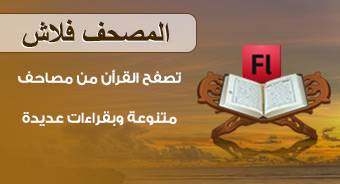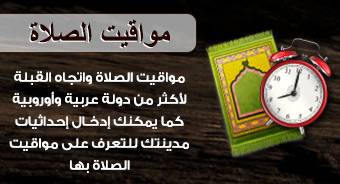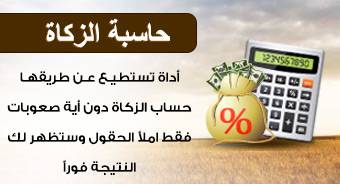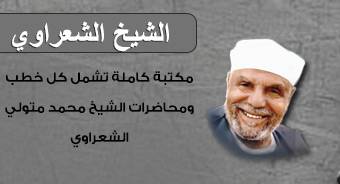|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي
فإن قلنا: إن الصبي إذا أتلف ما أودع عنده ضمنه.. كان الضمان هاهنا في رقبة العبد. وإن قلنا هناك: لا ضمان على الصبي.. كان الضمان هاهنا في ذمة العبد إلى أن يعتق. قال الطبري: وإن أودعه العبد شيئا، فقبضه.. فعلى من يرده المودع؟ فيه وجهان، حكاهما سهل: أحدهما: أنه بالخيار: إن شاء.. رده على العبد، وإن شاء.. رده على سيده. والثاني - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنه يرده على العبد دون السيد.
قال المسعودي [في "الإبانة" ق \ 441] ولا يلزم المودع حفظ الوديعة حتى يقبضها، والوديعة من العقود الجائزة، لكل واحد منهما أن يفسخها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك»، ولأن (أد): ملكها لصاحبها، والمودع متطوع بالحفظ، فكان لكل واحد منهما فسخها متى شاء، فإن مات أحدهما، أو أغمي عليه، أو جن، أو حجر عليه لسفه.. انفسخت الوديعة؛ لأنها عقد جائز، فانفسخت بما ذكرناه، كالوكالة. فإن حدث ذلك بالمالك.. فعلى المودع رد الوديعة إلى الوارث، أو إلى الولي، فإن أمسكها بعد تمكنه من الرد.. ضمنها؛ لأنا قد حكمنا بانفساخ الوديعة، وإن حدث ذلك للمودع.. فعلى وارثه أو وليه رد الوديعة؛ لأن مالكها لم يرض بأمانة غير المودع.
فإن شرط المودع الضمان على المودع.. لم يجب عليه الضمان بذلك، وهو قول كافة العلماء، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه قال: عليه الضمان. وهذا غير صحيح؛ لما ذكرناه من الخبر، فلم يفرق بين أن يشترط الضمان، أو لا يشترط، ولأن ما كان أصله الأمانة.. لم يصر مضمونا بالشرط، كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط. وإن أودعه جارية، أو بهيمة، فولدت عنده.. كان الولد أمانة؛ لأنه لم يوجد منه ما يقتضي الضمان، وهل يلزم المودع إعلام المالك بالولد؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمه ذلك، كما لو ألقت الريح إلى بيته ثوبا. والثاني: لا يلزمه ذلك، بل له إمساكه؛ لأنه لما أودعه الأم.. كان إيداعا لها ولما يحدث منها.
قال الشيخ أبو حامد: وهكذا: لو تركها المودع في جيبه أو كمه، أو أمسكها معه وهو يتطرق في طرقات البلد.. لم يضمن؛ لأن ذلك حرز لها بكون يده عليها. فإن تركها في حرز دون حرز مثلها.. ضمنها؛ لأن إطلاق الإيداع حرز مثلها، فإذا تركها فيما هو دونه.. صار متعديا، فضمن. وإن عين له المودع الحرز، بأن قال: أودعتك لتحفظها في هذا البيت فإن حفظها المودع في ذلك البيت، ولم ينقلها منه.. فلا كلام، وإن نقلها المودع منه إلى غيره، أو أحرزها في غيره.. نظرت: فإن لم ينهه المودع عن النقل، فإذا كان البيت الذي أحرزها فيه ابتداء دون البيت المعين في الحرز.. ضمنها المودع وإن كان حرزا لمثلها؛ لأن المودع لم يرض بما دونه، وإن كان مثله، أو أحرز منه.. لم يضمن؛ لأن من رضي حرزا.. رضي بمثله وبأعلى منه. وإن قال: احفظها في هذا البيت ولا تنقلها منه، فنقلها عنه.. نظرت: فإن نقلها إلى ما هو دونه.. ضمنها؛ لأنه لم يرض بدون ذلك البيت. وإن نقلها إلى مثله، أو إلى ما هو أحرز منه، فإن نقلها لغير خوف عليها.. فهل يضمن؟ فيه وجهان: أحدهما قال أبو سعيد الإصطخري: لا يضمن؛ لأنه نقلها إلى مثل الحرز المعين،، أو إلى ما هو أحرز منه، فهو كما لو لم ينهه عن النقل. والثاني قال أبو إسحاق: يضمن، وهو ظاهر المذهب؛ لأنه قطع اجتهاده بالتعيين، فخالفه بالنقل. وإن خاف عليها التلف في الحرز المعين من نهب، أو غزو، أو حريق.. فقد قال الشيخ أبو حامد، والمحاملي: جاز له نقلها؛ لأنه موضع عذر، فلا يضمن بالنقل، حتى تلفت.. فهل يجب عليه الضمان؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يضمن؛ لأنه ممتثل لأمره فيما فعل. والثاني: يضمن؛ لأنه غرر بها، حيث ترك نقلها مع الخوف عليها. وذكر الشيخ أبو إسحاق في "المهذب": إذا كان النهي عن النقل مطلقا، وخاف عليها.. لزمه نقلها، وجها واحدا، فإن لم ينقلها حتى تلفت.. لزمه الضمان، وإنما الوجهان إذا قال: لا تنقلها وإن خفت عليها الهلاك.
أحدهما: وهو المذهب - أنه لا ضمان عليه؛ لأنه زاده خيرا. والثاني - وهو قول مالك - (أنه يضمن)؛ لأن ذلك يغري السارق بها. وإن قال: احفظها في هذا البيت، ولا تدخل غيرك إليها، فأدخل جماعة إليها، فإن سرقها واحد من الذين أدخلهم عليها، أو دلوا عليها من سرقها.. وجب على المودع الضمان؛ لأن تلفها حصل بالوجه المنهي عنه، وإن تلفت بسبب من غير الداخلين عليها، بأن انهدم عليها البيت، أو سرقها غيرهم، ولم يدل عليها أحد منهم.. لم يجب على المودع الضمان؛ لأن تلفها لم يحصل من الوجه المنهي عنه.
وإن دفع إليه وديعة في السوق، وقال: أحرزها في البيت، ولا تربطها في ثيابك.. قال الشافعي: (فإنه لا بد له من ربطها في ثيابه إلى أن يوصلها إلى البيت، فإن حملها في الحال إلى البيت.. لم يضمن، فإن تلفت في الطريق، أو على باب الدار، أو تعوق لتعسر الغلق.. لم يضمن؛ لأنه غير مفرط، وإن توانى في حملها إلى بيته.. ضمن؛ لأنه تعدى بذلك). قال الشيخ أبو حامد: فإن تركها في دكانه - وهو حرز مثلها - إلى أن يرجع إلى داره بالعشي، أو أكثر.. لم يضمن؛ لأنه مثل البيت في الحرز.
وقال في "الأم": (إذا قال: أحرزها في كمك، فأحرزها في يده.. ضمنها، فإن غولب عليها، فأخذت من يده.. لم يضمن). قال الشيخ أبو حامد: والربط هاهنا: عبارة عن الجعل. واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة طرق: فـالأول: منهم من قال: فيه قولان: أحدهما: لا يضمن؛ لأن اليد أحرز من الكم؛ لأن الطرار يمكنه أن يبط الكم، ولا يمكنه ذلك في الكف. والثاني: يضمن، لأن الكم أحرز من اليد؛ لأنه قد يسهو فيرسل يده، فيسقط ما كان بها، وإذا ترك شيئا في الكم.. فإذا سقط.. أحس به. والطريق الثاني قال أبو إسحاق: ليست على قولين، بل هي على حالين: فحيث قال: (لا يضمن) أراد: إذا ربطها في الكم، وقبض عليها بيده لأنه زاده خيرا. وحيث قال: (يضمن) أراد: إذا تركها في يده من غير أن يربطها في الكم؛ لأن الكم أحرز. وقال الشيخ أبو حامد: هي على حالين آخرين: فحيث قال: (لا يضمن) أراد: إذا خاف عليها في كمه الاستلاب، فتركها في يده. وحيث قال: (يضمن) أراد: إذا تركها في يده من غير خوف. و الطريق الثالث قال المسعودي [في "الإبانة" ق \ 443] إن كان تلفها بانتزاع الغاصب من يده.. لم يضمن؛ لأن الكف أحرز في هذه الحالة، وإن كان التلف بأن نام، أو غفل، فأرسل كفه فسقطت ضمن؛ لأن الربط في الكم أحرز في هذه الحالة. وإن أودعه وديعة، وقال: أمسكها في يدك، فربطها في كمه.. فعلى الطريقة الأولى: يكون هاهنا على قولين، وعلى الطريقين الآخرين: الكم أحرز هاهنا. وإن أمره أن يتركها في كمه، فتركها في جيبه.. لم يضمن؛ لأنه أحرز من الكم، وإن أمره أن يتركها في جيبه، فتركها في كمه.. ضمن؛ لأن الكم دون الجيب في الحرز.
وإن أودع حاضرا، وأراد المودع السفر، فإن وجد المالك، أو وكيله المطلق أو المقيد بقبض ودائعه.. ردها إليه؛ لأن الوديعة عقد جائز، فكان له فسخها متى شاء، وإن لم يكن المودع ولا وكيله في البلد، أو كان في البلد، إلا أنه لا يقدر على الوصول إليه، بأن كان محبوسا، وهناك حاكم.. دفعها المودع إليه، كما لو أرادت المرأة أن تتزوج ووليها غائب، فإذا لم يكن حاكم في البلد.. دفعها إلى أمين؛ لما روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت عنده ودائع بمكة، فلما أراد الهجرة.. أودعها أم أيمن، وخلف عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ليردها». فإن دفعها إلى الحاكم، أو الأمين مع قدرته على المالك، أو وكيله.. ضمنها، كما لو زوج الحاكم المرأة مع وجود وليها، وفيه وجه آخر: أنه لا يضمن إذا دفعها إلى الحاكم؛ لأن الحاكم يقوم مقام المالك، ويده كيده. وليس بشيء. فإن دفعها إلى أمين مع وجود الحاكم.. فقد قال الشافعي: (فإذا سافر بها، فأودعها أمينا يودعه ماله.. لم يضمن). واختلف أصحابنا فيه: فقال أبو إسحاق: لا يضمن؛ لأن الشافعي لم يفرق. وبه قال مالك؛ وأبو حنيفة، واختاره الشيخ أبو حامد؛ لأنه أودعها أمينا لعذر السفر، فهو كما لو كان الحاكم معدوما في البلد. وقال أبو سعيد الإصطخري، وأبو علي بن خيران: يجب عليه الضمان؛ لأن الشافعي قال في (الرهن): (وإذا وضع الرهن على يدي عدل، ثم غاب المتراهنان، أو أحدهما، وأراد العدل السفر.. دفعه إلى الحاكم). فدل على: أن الدفع إلى غيره لا يجوز، ولأن أمانة الحاكم مقطوع بها، وأمانة الأمين مجتهد فيها، فلم يجز ترك المقطوع به إلى المجتهد فيه، كما لا يجوز ترك النص إلى القياس. ومن قال بالأول.. حمل نص الشافعي في (الرهن) إذا تشاح المتراهنان في العدل.. فإنهما يرفعانه إلى الحاكم ليضعه عند عدل. وإن خالف، وسافر بها، فإن لم يكن به ضرورة إلى السفر.. ضمنها، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وسواء كان الطريق آمنا أو مخوفا. وقال أبو حنيفة: (إذا كان الطريق آمنا: لم يضمن، إلا أن يكون قد نهاه عن السفر). وبه قال بعض أصحابنا؛ لأنه يكون كنقل الوديعة من محلة في البلد إلى محلة فيها. وهذا غلط؛ لأن أمن السفر غير موثوق به، فقد يحدث الخوف في الطريق، بخلاف محال البلد. وإن دعته إلى السفر ضرورة بأن هجم على البلد فتنة، أو حريق، أو غرق، ولم يجد من يأمن عليها من ذلك عنده.. قال الشيخ أبو حامد: فله أن يسافر بها، ولا يضمن وإن كان الطريق مخوفا؛ لأن هذا موضع ضرورة؛ لأنه لا يتمكن من شيء غير ذلك. وذكر الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" [1/363] إذا أراد السفر ولم يجد المالك، ولا وكيله، ولا الحاكم، ولا الأمين.. لزمه أن يسافر بها؛ لأن السفر في هذه الحال أحوط.. ولعله أراد: إذا خاف في البلد، كما قال الشيخ أبو حامد.
فإن كانت القرية الثانية مثل الأولى في الأمن، أو أعلى منها.. لم يضمن، كما لو نقل الوديعة من بيت في دار إلى بيت فيه مثله. وإن كانت الثانية دون الأولى في الأمن.. ضمنها؛ لأن الظاهر ممن أودع غيره وهو في قرية أو محلة، أنه رضي بها حرزا دون غيرها. وإن كانت القريتان منفصلتين، فإن كان الطريق بينهما مخوفا، أوالثانية دون الأولى في الأمن.. ضمنها المودع؛ لأنه غرر بالوديعة، وإن كان الطريق آمنا، والثانية كالأولى في الأمن. ففيه وجهان: أحدهما: لا يضمن، كما لو نقل الوديعة من دار في البلد إلى دار أخرى فيه. والثاني: يضمن، وهو المذهب؛ لأن أمن السفر غير موثوق به.
فإن أعلم بها فاسقا.. ضمنها؛ لأنه زاد في التغرير بها. وإن أعلم بها أمينا، فإن كان غير ساكن في تلك الدار.. ضمنها؛ لأنه لم يودعه، إذا لم يقبضه إياها، وإن كان ساكنا في تلك الدار، ولم يقدر على المالك، أو وكيله، أو الحاكم.. ففيه وجهان: أحدهما: لا يضمن؛ لأن الشافعي قال: (إن لم يعلم بها أحدا.. ضمن). فدل على: أنه إذا أعلم أمينا.. لم يضمن، ولأنه يجوز له إيداعها عند أمين في هذه الحالة، وهذا إيداع. والثاني: يضمن؛ لأن هذا إعلام، وليس بإيداع؛ لأن الإيداع هو: أن يسلمها إليه، فتصير مقبوضة، وهذا لم يقبضه إياها. قال الشيخ أبو حامد: وهذا ضعيف؛ لأنه إن كان ساكنا في الموضع، وأعلمه بالوديعة.. فقد أودعه إياها.
فمنهم من قال: أراد: إذا كان قادرا على المالك، أو وكيله؛ لأنه لا يجوز له إيداعها مع وجود أحدهما. ومنهم من قال: أراد: إذا لم يقدر على المالك، ولا وكيله، ولم يودعها عند الإمام، ولكن وضعها في بيت المال، فيضمن؛ لأنه ما أودعها عند أحد. وأيهما أراد الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.. فهو صحيح في الفقه.
ومن أصحابنا من قال: لا يضمن؛ لأن الحاكم يقوم مقامه، ويده كيده. قال الشيخ أبو حامد: وهذا ضعيف، فإن لم يشهد على الوديعة، ولم يوص بها ومات.. ضمنها؛ لأنه غرر بها؛ لأن الظاهر مما في يده أنه ملكه. وإن مات، فوجد بخطه أن الكيس الفلاني لفلان، أو وجد على الكيس اسم رجل.. لم يحكم له به؛ لأنه قد يودعه غيره شيئا، ثم يتملكه، أو يشتري كيسا عليه اسم رجل. وإن ادعى رجل أن هذه العين وديعة لي أودعتها الميت، وأقام على ذلك شاهدين.. قال الشيخ أبو حامد: حلف معهما، وحكم له بالوديعة. وإن قال: عندي لفلان وديعة، ووصفها بصفة، أو قامت بينة بذلك، أو أقر الورثة بذلك، فمات ولم توجد تلك الوديعة.. فقد قال الشافعي: (ضمنت في مال الميت، ويحاص بها الغرماء). واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه: فـالأول: قال أبو إسحاق: أراد: إذا قال ذلك عند الوفاة، وقرب الموت؛ لأن الظاهر أنه أتلفها، فيكون قوله: عندي، عبارة عن قوله: علي، فأما إذا قال في صحته: أودعني فلان وديعة، ووصفها، ومات ولم توجد.. لم يجب عليه الضمان؛ لجواز أن تكون تلفت بعد ذلك بغير تفريط، ففرق بين طول المدة، وقصرها. والوجه الثاني منهم من قال: إن مات، ووجد في ماله من جنس تلك الوديعة، واشتبه ماله بالوديعة.. فعليه الضمان؛ لأنه فرط، إذ لم يبينها بيانا يزول به الإشكال، وإن لم يكن في ماله من جنس الوديعة.. لم يجب عليه الضمان؛ لجواز أن تكون قد تلفت من غير تفريط. والوجه الثالث منهم من قال: لا يجب عليه الضمان، وهو المذهب؛ لأن الأصل براءة ذمته من الضمان، وحمل النص عليه إن عرف أن عنده وديعة ببينة، أو إقرار الورثة، ومات ولم يوص بها.
وحكى ابن الصباغ وجها آخر: أنه إذا أودعها الحاكم مع غيبة المالك، أو وكيله من غير ضرورة.. لم يضمن. وقال أبو العباس: إنما يضمنها إذا سلمها إلى الذي أودعها إياه لينفرد بتدبيرها، فأما إذا استعان به في سلتها، أو في إغلاق الباب، أو في فتحه، أو في الإتيان بها إليه، بحيث لا تغيب عن نظر المودع.. فلا ضمان عليه، وهذا كما نقول فيمن أودع بهيمة.. فليس عليه أن يعلفها ويسقيها بنفسه، بل إذا تقدم بذلك إلى خادمه، أو سائسه.. جاز، ولا يضمن. هذا مذهبنا. وقال مالك: (إن أودعها زوجته.. لم يضمن، وإن أودعها غيرها، من عبده، أو غيره.. ضمنها). وقال أبو حنيفة: (إن أودعها من يعوله، وينفق عليه، مثل زوجته، أو خادمه أو امرأة في داره يعولها.. فلا ضمان عليه). ودليلنا: أنه أودع الوديعة من لم يأتمنه المودع، فضمنها، كما لو أودعها أجنبيا. فإن هلكت الوديعة عند المودع الثاني من غير تفريط منه.. فللمالك أن يضمن إن شاء منهما؛ لأنهما متعديان؛ فإن ضمنها للمودع الثاني.. نظرت في الثاني: فإن علم الحال.. لم يرجع بما ضمنه على الأول؛ لأنه رضي بوجوب الضمان على نفسه. وإن لم يعلم.. فهل له أن يرجع على الأول؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يرجع؛ لأنها هلكت عنده، فاستقر الضمان عليه. والثاني: يرجع عليه؛ لأنه غره، ولم يدخل معه ليضمن، وإنما دخل معه على أنها أمانة. وإن رجع المالك على المودع الأول، فإن كان الثاني قد علم أنها وديعة أودعت عنده من غير ضرورة. رجع الأول عليه؛ لأن الثاني رضي بوجوب الضمان عليه، وقد وجد الهلاك في يده، فاستقر الضمان عليه، وإن لم يعلم بالحال.. فهل للأول أن يرجع عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: يرجع عليه؛ لأن الهلاك كان في يده. والثاني: لا يرجع عليه؛ لأنه لم يدخل معه على أن يكون ضامنا.
وإن خلطها بدراهم له، أو أودعه شيئا من ذوات الأمثال، فخلطه بمثله من ماله.. لزمه الضمان، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: (لا يلزمه الضمان؛ لأنه خلطه بمثله). وهذا غلط؛ لأنه خلطه بما لا يتميز عنه من ماله بغير إذن المالك، فلزمه الضمان، كما لو خلطها بأردأ منها. وإن خلطها بمثلها من مال المودع.. ففيه وجهان: أحدهما: لا يضمن؛ لأن الجميع له. والثاني: يضمن؛ لأنه لم يرض باختلاطهما. |